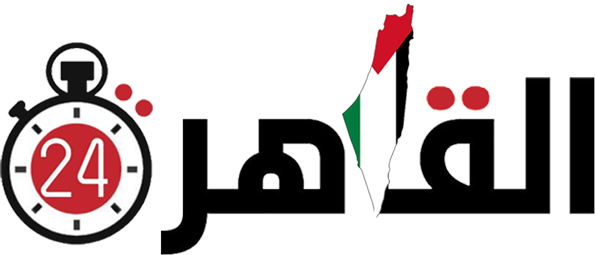نريد دستورا جديدا.. كيف أفسدت لجنة الأشقياء (الخمسين سابقا) مستقبل مصر السياسي؟ (رؤية تحليلية)

الدساتير وثائق تأسيس سياسي عابرة للزمن، لا يُفترض فيها أن تتورط في تعقيدات المشهد السياسي وقت كتابتها، أو تستجيب لتوازنات القوى الفاعلة فيه، وتسير وفق منطق المحاصصة والأوزان النسبية، ولكن للأسف يبدو أن دستور 2014 سقط في كل هذه المحظورات، بإرادة عمدية من كاتبيه، الذين أنشبوا مخالبهم في جسده وجسد الدولة، وكأنهما فريسة للصراعات الشخصية، وكأنهم هم قطيع من الذئاب.
أخطر ما تتعرض له الأوطان أن تختطف جماعات المصالح أحداثها المفصلية، سعيا لتحقيق أهداف شخصية ومراكمة مكاسب فئوية، دون أن تلتفت إلى ما يواجهه الوطن من تحديات، وما يتطلع إليه من طموحات، تستلزم انتهاج منظومة من الإجراءات والتدابير الموضوعية العاقلة، لتحصين مستقبل أجياله المقبلة.
الأخطر مما سبق، أن ترتدي هذه الجماعات – وهي تسرق منجزات شعوبها – رداء الوطنية، فيخرج فعلها عن دائرة النقد، ويصبح الاقتراب منه مجازفة يمكن أن تنتهي بتعليقك على أعواد المشانق.
البلاد التي تواجه تحديات ضخمة كتبعات لحدث سياسي جوهري، مثل ثورة 30 يونيو وما أعقبها من إرهاب وخيانة في الداخل، وتآمر واستهداف دولي من الخارج، تتعلق عيون شعوبها بأي فرصة حقيقية للخلاص والإنقاذ، الذي لا يكون إلا بعقد اجتماعي يعيد صياغة منظومة العلاقات بين أفراد المجتمع وفق قواعد واضحة: لا حكم باسم الدين، لا استبداد، لا فساد، لا تكاسل أو إهمال، وهذا العقد هو الدستور الجديد، الذي كان يُفترض أن يكون جديدا فعلا، لكن أفسدته علينا لجنة الخمسين.
وفي التاريخ المصري الحديث يمكننا المقارنة بين حدثين جوهريين، كلاهما شهد وضع دستور جديد للبلاد، الأول كان تحت الاحتلال الأجنبي، والثاني تحت رصاص الإرهاب ومحاصرة الخارج لنا، لكن النتائج كالفارق بين السماء والأرض.
في 3 أبريل 1922 شكّل رئيس وزراء مصر الأسبق، عبد الخالق باشا ثروت، لجنة لوضع دستور جديد، عُرفت بـ«لجنة الثلاثين»، لكنها قوبلت برفض شعبي وسياسي واسع، إلى حد أن هاجمها سعد باشا زغلول وخلع عنها رداء الوطنية، واصفا إياها بـ«لجنة الأشقياء»، وقد انتهت هذه اللجنة، التي عملت وهي محاصرة بين احتلال ورفض سياسي، إلى وضع دستور 1923، أحد أفضل دساتير مصر في تاريخها، ما دفع القوى الوطنية المصرية كلها للنضال لاحقا من أجل عودته، بعد وقف العمل به في 1930.
الحدث الثاني كان في الأول من ديسمبر 2013، مع إصدار الرئيس عدلي منصور قراره رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، لدراسة مشروع التعديلات الدستورية الذي وضعته لجنة الخبراء «لجنة العشرة»، المشكّلة قبل ذلك بنحو 3 أشهر، ورغم أن لجنة الخمسين تمتعت بصلاحيات واسعة ومساحة كافية من الوقت والدعم السياسي الرسمي والشعبي، إلا أنها انتهت إلى وثيقة لا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال إلا بـ”دستور مصالح”، هذه الوثيقة هي دستور 2014 الذي يحكم البلاد الآن.
هنا قد يحق لنا التساؤل: أي اللجنتين تستحق لقب “لجنة الأشقياء”، التي وضعت دستورا من أفضل دساتير مصر (1923)، أم التي وضعت دستورا مليئا بالفخاخ والنصوص المرشحة للانفجار وخلق أزمات سياسية (دستور 2014)؟.
لجنة الأشقياء (الخمسين سابقا)
في الوقت الذي كانت فيه مصر دولة محاصرة بشكل خانق، بين إرهاب وخيانة في الداخل، وتآمر دولي من الخارج، كان هناك 50 سياسيا، كل منهم يمثل فئة، يجتمعون تحت قبة مجلس الشورى؛ لتقسيم كعكة المصالح، وهم يرشفون نخب الزهو والانتصار، بينما تنطرح تحت أقدامهم جثة وطن يعاني وضعا حرجا، ويبحث عن أي منقذ يقوده إلى المستقبل.
انتهت تلك العملية المشوهة بالمحاصصة والتوازنات، إلى دستور صِيغ وفق أجندات كثيرين من المشاركين، ممن كانت لهم وقتها كلمة مسموعة، قبل أن تتكشف أمام الرأي العام انتهازية أغلبهم، والأدلة العملية الدامغة على عملهم لصالح فئاتهم واقتناص أكبر قدر من المكاسب الشخصية، حتى لو تعارض هذا المسلك مع المصلحة العامة.
لك أن تتخيل مثلا أن مسعد أبو فجر، الذي يهاجم الدولة المصرية والقوات المسلحة ليل نهار، ويعتبر حرب الجيش على الإرهاب «حرب إبادة ضد أهالي سيناء» بحسب تعبيراته العدائية المتطرفة، كان عضوا في لجنة الخمسين، ممثلا عن أهالي سيناء، وكأن أرض الفيروز قد عدمت الرجال والأبطال، أمثال حسن خلف وغيره من شيوخ القبائل، ليتم اختيار «أبو فجر» ممثلا لها ولتاريخها النضالي، بينما ينضح واقعه بالتواطؤ والحملات المسعورة على الدولة وأمنها القومي.
في جولاتها الطويلة المشبوهة، تعاملت لجنة الأشقياء (الخمسين سابقا) مع عملية وضع الدستور باعتبارها حفل عيد ميلاد، ومناسبة عائلية لتقسيم التورتة وتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب الفئوية والسياسية، لصالح التيارين الغالبين على أعضاء اللجنة (اليساري والقومي الناصري)، رغم أن أغلب هؤلاء ما كان لهم حق التواجد أصلا في مرحلة التأسيس الدستوري لدولة ما بعد 30 يونيو، باعتبارهم من الحلفاء القدامى لجماعة الإخوان الإرهابية.
ألم يذهب الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار ومحمد سامي وغيرهم من أعضاء اللجنة، بصفاتهم السياسية والشخصية، إلى مؤتمر فيرمونت الشهير لدعم مرشح الإخوان محمد مرسي، بحثا عن أي مكاسب؟.
تلك المجموعة، التي فشلت فشلا ذريعا في النهوض بأحزابها وتياراتها السياسية، وقت أن كان المجال العام لا سقف له، والعمل السياسي لا حدود لانفتاحه، وذهبت للمتاجرة بأحلام الجماهير المشاركة في 25 يناير على طاولة الجماعة الإرهابية، لدعم مرسي في مواجهة أحمد شفيق، مقابل وعود لم تحقق، هل يُعقل أن تكون ضمن لجنة الخمسين وتكتب دستور الثورة، التي خرجت رافضة تحالفاتهم المشبوهة مع الإخوان؟.
في هذا الإطار، أحيلكم إلى ما قاله الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وأحد أشد المعارضين للنظام الحالي، وعضو “مؤسسة حماية الدستور” المشكلة لمواجهة أي محاولة لتعديل الدستور، في مداخلة هاتفية مع برنامج “في الميدان” يوم 6 نوفمبر 2013، قال فيها نصا: “الإخوة والزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية التأسيسية حولوا عملية وضع الدستور إلى ما يشبه الكعكة الكبيرة، التي يريد كل منهم أن يقضم أكبر قضمة منها”.
وأضاف «فرحات» في مداخلته، أن “كل منهم يريد أن يعود إلى أهله وعشيرته، ويقول لهم لقد أدركت ما لم تدركوه، وفزت بأكبر نصيب من الكعكعة، ولكن ليس هكذا تُوضع الدساتير”.
وقتها حذّر نور فرحات ذاته أعضاء لجنة الخمسين من الدخول في معارك حول مواد الهوية الإسلامية، معتبرا أن مثل هذه المعارك مناورة سياسية ستؤدي في النهاية لتدمير المستقبل الدستوري لمصر، وهو ما لم يستمع له أعضاء اللجنة، الذين غالوا في تأكيد فكرة الهوية الإسلامية.
موقف نور فرحات يثير تساؤلا مهما، وهو «كيف يحذر الرجل من أن النص على الهوية في دستور 2014 يدمر مستقبل البلاد الدستوري، والآن يدافع عن هذا الدستور؟».. ربما لا يملك فرحات إجابة، والأمر نفسه بالنسبة لكل من اتخذوا مواقف شبيهة، لكن الإجابة يمكن تلخيصها باختصار في “الكيد السياسي”.
وقد كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري البارز، عما فعلته تلك المجموعة من أشياء ترقى لمرتبة الجريمة في حق التأسيس الدستوري والمستقبل السياسي لمصر، قائلا في تصريحات لموقع “مدى مصر” في يوليو الماضي، إن “السبب في الخروج بمثل هذا الدستور هو عدم استجابة أعضاء لجنة الخمسين لنصائح لجنة العشرة، وقت إعدادها للمسودة النهائية للدستور، فقد سلّمناهم مسودة تضم 197 مادة بالديباجة، فأدخلوا عليها تعديلات كثيرة، حتى وصلت المسودة إلى 247 مادة، ولم يهتموا باعتراضنا على صياغتهم لبعض المواد”.
الديباجة
تكشف القراءة المتأنية لديباجة دستور 2014، أن بها إطالة لا قيمة سياسية لها، وهي ركيكة في صياغتها، ضعيفة في أسلوبها، يغلب عليها الطابع الشعري، أكثر من السياسي، تمجّد الماضي على حساب المستقبل، ولا تُولي أهمية كبيرة لفكرة أن الدساتير وثيقة إنسانية سياسية لبناء المستقبل، وذلك وفقًا للمقارنة السريعة بينها وبين ديباجات دساتير أخرى كالأمريكي والفرنسي والياباني والبولندي والجنوب أفريقي.
تستند الديباجة على تصور خاطئ مفاده أن “العالم يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته المصالح بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب”، وهو استناد غير صحيح، إذ أثبتت السنوات التالية لوضع الدستور، واشتعال الصراع في الشرق الأوسط، فشل هذا السيناريو التخيلي، بينما تحولت المنطقة ومناطق أخرى بالعالم لساحة حرب مفتوحة.
كان لا بد من أن تأخذ هذه اللجنة في اعتبارها أهمية حماية الدولة في ظل هذه الصراعات العالمية، التي لا تكف عن التحرش بوطننا، إما بتصدير الإرهابيين لنا، أو بالإضرار بنا اقتصاديا، لأنها تؤثر سلبا على حركة التجارة في المنطقة، وبالتالي تؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، ما يؤكد هنا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، وثبيت أركانها ودعائمها.
كما أن هذه الديباجة الركيكة تنافق المؤسسة الدينية “الأزهر”، وتنافق الشريعة الإسلامية، وذلك على حساب غيرهما من المؤسسات والشرائع، ونحن لا نغفل أن الأغلبية مسلمة، لكن المسألة تستوجب النظر في ضوء تعدد مكونات الدولة المصرية وتنوعها، لأن هذا القصر والاختزال أعطى من يتشدقون باسم الدين مساحة أكبر مما يستحقون، وأسهم بشكل كبير في استمرار حالة “تديين المجال العام”، وخلق من الأزهر دولة موازية للدولة، فكانت الضجة التي حدثت عندما أشار أحد نواب البرلمان – مجرد إشارة – إلى نيته تقديم تعديلات على قانون الأزهر الشريف.
الهوية
بدا واضحا خلال مناقشات أعضاء لجنة الخمسين (الأشقياء) للتعديلات الدستورية، أن لديهم أزمة في تحديد هوية مصر، كدولة لها هوية متفردة، من المفترض أنها لا تُعرّف بالإضافة ولا تُنسب إلى عوالم أخرى سوى عالمها الإنساني، فأضاعوا علينا فرصة كبيرة لثورة دستورية اجتماعية، ترفض كل أسباب سيطرة وتغلغل التيارات الدينية فى المجتمع المصري، وأولها ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات في دستور 1971.
ربما خضع أعضاء اللجنة لابتزاز الدعاية الإخوانية في الداخل والخارج، وزعمها أن ثورة 30 يونيو وما تبعها يمثل ثورة على الإسلام، وإن كان ذلك قد حدث بالفعل، فما كان لنا أن نسمح باستمرارهم في كتابة الدستور، فكيف يكتب الدستور أصحاب نفسيات مرتعشة أمام أكاذيب إرهابية؟!.
المؤسف أن أعضاء اللجنة سيطرت عليهم حالة من قصور النظر، وربما قصور الوعي، فظنوا أن النص في الديباجة على تعريف مبادئ الشريعة أمر كافٍ، فقالوا: “نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن”.
الآن، وبعد سنوات من وضع الدستور وسريانه، يحق لنا دراسة نتيجة هذا النص، والبحث عن إجابات للأسئلة المهمة المحيطة به، وفي مقدمتها هل استطعنا أن نُحصّن المجتمع من جريمة الطلاق الشفوي؟ هل استطعنا أن ننصف المرأة في قضية المواريث كما فعلت تونس؟ هل استطعنا أن ننصف الأقباط ونفتح أمامهم الكليات العلمية بجامعة الأزهر مثلا؟ هل تتعارض أحكام المحكمة الدستورية العليا مع كل الأمور السابقة؟ وإن كان هناك ثمة تعارض وصدام بين هذه الأمور وتلك الأحكام، فما القيمة والفائدة العملية التي عادت علينا من الاحتكام إليها؟
القصة كلها تتلخص في أن اللجنة عملت على مسودة الدستور بمنطق قطيع الذئاب فعلا، ولم ينشغل أعضاؤها إلا بالحصص الفئوية من المكاسب والامتيازات، وهكذا أبقوا على المادة الثانية من الدستور بنصها الموروث والمفخخ: “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
المعروف تاريخيا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قدم هذه المادة رشوة للتيارات الإسلامية، وهو الخطأ التاريخي الذي ساعد على إدخال مصر في أزمة “تديين المجال العام”، وفتح الباب على مصراعيه لتيارات الإسلام السياسي لابتزاز مشاعر المواطنين، والمزايدة على المؤسسات والمسؤولين، والأخطر دفع مصر دفعا غشوما إلى دوامة العنف والإرهاب.
لقد أضاع هؤلاء الأشقياء علينا فرصة عظيمة للقضاء على هذه الحالة المجتمعية “تديين المجال العام”، تميهدا لتأسيس دولة مدنية حديثة، لا يرى فيها أي مواطن أن له فضلا على غيره من المواطنين، المتساوين معه في الحقوق والواجبات وأمام ميزان القانون والدستور، إلا بالعمل الجاد وإعلاء مصالح الوطن.
لو كانت لجنة الخمسين تؤمن حقا بهذه البديهية الدستورية، وتعمل من منطلق يصون حقوق المجموع العام، ويحفظ السلم الاجتماعي، فلماذا لم ترفض سجن الوثيقة الدستورية في ملعب الأغلبية، والنقر على الوتر الطائفي الذي أدمنته التيارات الدينية؟ وإن كان لا مفر من النص على مرجعية عليا للدستور، ومصدر أساسي للتشريع، فلماذا لا تكون “المبادئ الإنسانية الواردة في الكتب السماوية” هي المصدر الرئيسي للتشريع، لو كانت النوايا خالصة حقا لوجه الوطن؟!.
من الكوارث الأخرى الخاصة بمسألة الهوية في الوثيقة الدستورية، المادة السابعة التي تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولي مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
هذه المادة «الفخ» تُحوّل مؤسسة الأزهر إلى دولة داخل الدولة، كما أنها تُحصّن شيخ الأزهر دون مبرر، رغم أننا اكتشفنا خلال السنوات الماضية سيطرة سلفيين وهابيين ومنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على مفاصل قيادية بالمؤسسة، وهنا يبرز سؤال مهم: ماذا لو وصل في غفلة من الزمن أحد المنتمين للتيارات التكفيرية إلى كرسى الإمام الأكبر؟! وماذا لو قرر شيخ الأزهر ذات مرة معارضة مواقف وسياسات الدولة أو الانحياز لسياسات ومواقف دول أخرى؟.. ربما تكون واقعة “الطلاق الشفوي” خير دليل على ذلك، وفي ضوء مماطلة مؤسسة الأزهر وتحديها لمؤسسات الدولة في اتجاه إصلاحي لضبط منظومة الأحوال الشخصية في البلاد، من يضمن لنا ألا تدخل الدولة الساعية للواقع المدني في صدام مع المؤسسة الغارقة في التراث؟.
وإن كان لا بد من اشتمال الدستور على مادة عن الأزهر، فلماذا لا تكون هكذا “الأزهر الشريف هيئة علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على تطوير الخطاب الديني بما يتسق ومتطلبات العصر، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وشيخ الأزهر يُعيّن لمدة محددة، ويجوز عزله حال الإخلال بمهامه التي حددها الدستور، وينظم القانون اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما ينظم سحب الثقة منه”.
أزمة الهوية لم تقف عند حدود مواد الشريعة الصريحة، لكنها بدأت مع المادة الأولى التي تقول “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل علي تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تتنتمي إلي القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية”.
الملاحظ أن صياغة هذه المادة تغيرت في الدساتير الثلاثة، 1971، و2012، و2014، بإضافة بعض الامتدادات على تعريف مصر.. ورغم هذه التعديلات فقد ظلت هناك إشكالية واضحة فيما يخص شرح امتدادت مصر، التي كان من المفترض أن تكون «مصر جزء من العالم الإنساني تعتز بعمقها العربي والأفريقي والآسيوي والإسلامي».
علاقة الرئيس بمجلس النواب والحكومة
حاول واضعو دستور 2014، تحجيم رئيس الجمهورية، بمنح مجلس النواب ورئيس الحكومة صلاحيات أوسع من التي مُنحت لهما في الدساتير السابقة، وبهذا الانحياز غير المؤسس على منطق دستوري وتشريعي، ذهبوا بمصر صوب حالة من التنازع السياسي، والصيغة الهيكلية المشوهة، بشكل غير متوازن، ويحمل داخله بذور تعويق وتعطيل لمؤسسات الدولة، إذ خرجت الصورة الأخيرة لنظام الحكم في مصر في هيئة عجيبة ولا منطق فيها، فلا هي بالنظام البرلماني، ولا الرئاسي، ولا حتى المختلط، وأقرب وصف يمكن أن يكون دقيقا هو أنه «نظام مختلط يضمن عرقلة أكبر للرئيس»، إن كان هذا التوصيف العجيب مقبولا عند أهل العلوم السياسية.
الدستور الجديد نظّم العلاقة بين الرئيس والحكومة في 8 مواد، منها المادة (147) التي تنص على أنه من حق الرئيس إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له طبقا للمادة أن يجري تعديلا وزاريا بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. هنا تضم المادة فخا كبيرا، فماذا لو رفضت الأغلبية طلب الرئيس بإعفاء الحكومة؟ هل يعمل مع حكومة لا يقبلها؟ أم ندخل في أزمة دستورية تصل إلى حد إقدام الرئيس على طلب سحب الثقة من البرلمان أو العكس؟ وهو ما ينقلنا إلى المادة (161) التي تعطي مجلس النواب حق التحرك لسحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فما العمل لو قدم أغلبية أعضاء المجلس طلبا باقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأسباب فى أنفسهم؟ وماذا لو جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض؟.
من واقع هذه الصياغات المرتبكة والمتعارضة، يبدو أن لجنة الخمسين تعمدت حشرنا في مناخ سياسي غير مستقر، يضع العربة أمام الحصان، ويُهدد استقرار البلد ومستقبله، ولأنهم كانوا متورطين في لعبة الاستقطاب وصراعات المصالح حتى آذانهم، لم يسمعوا النصائح والملاحظات والانتقادات، وبالتبعية لم يفهموا أن هذا التنازع في المصالح وحسابات المكاسب الفئوية سيخلق تشوّهًا هيكليا عميقا، بشكل يعطل المسيرة، ويضع الدولة ومؤسساتها على المحك، ويجبر الجميع على التوقف بعد أربع سنوات فقط من وضع الدستور، بحثا عن حلول عملية للمشكلات، التي تفننوا في صنعها.
المؤكد أن الصيغة القائمة في الوثيقة الدستورية لا تتوافق مع طبيعة العصر، ولا تتأسس على منطق قانوني ودستوري، وهي وثيقة تعطيل أكثر من كونها وثيقة تسيير، ولا حل لغابة التعقيدات الكثيفة التي نسجتها حول الدولة ومؤسساتها إلا بالنظر الفاحص والناقد لها، ليس بغية التعديل، لأنها وثيقة تستعصي على التعديل بسبب كثافة تناقضاتها، وإنما لإعادة كتابتها بشكل مغاير وأكثر وعيا.
التصدي لكتابة وثيقة دستورية لدولة مثل مصر، لا يمكن أن ينطلق من الفراغ، أو يتجاهل ميراث القانون الدستوري المصري في قرنين، منذ وضعت مصر أول وثيقة ذات طابع دستوري، وفي ضوء هذه الفلسفة ربما يمكن الجزم بأن مصر لا يصلح معها النظام البرلماني أو المختلط، ولا تستقر أوضاعها إلا في ضوء نظام رئاسي صريح، لا يغل يد الرئيس، ولا يخلق مراكز سلطة أخرى تتصارع مع قلب السلطة بشكل يُعطل قاطرة الدولة، وإن كان لا بد من خلق حالة من الديمقراطية والرقابة، فيمكن تشديد رقابة النواب على الحكومة، لكن مع سحب صلاحيات رئيس الحكومة وإعادتها للرئيس مرة أخرى، مثلما كان الحال في دستور 1971، على أن يظل الرئيس حكما بين السلطات، قائدا لدفة العمل الوطني، بعيدا عن المناوشات السياسية، التي قد تحدث بين الحكومة والبرلمان.
من بين المواد المفخخة التي تضع قيودا على منصب الرئيس أيضا، المادة (127) التي تمنع السلطة التنفيذية من الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروعات غير مدرجة فى الموازنة العامة إلا بعد موافقة النواب.. فماذا لو رفض النواب، أو تأخروا في الموافقة، كما يحدث الآن مع كثير من القوانين والتشريعات المهمة؟ هل تتأخر مشروعات التنمية وتتعطل مصالح الدولة بسببهم؟.. كان الأفضل أن تأتي موافقة البرلمان كرأي استشاري لاحق على عقد هذه الاتفاقيات، خاصة أن الوثيقة الدستورية كغيرها من الوثائق لا بد من أن تنطلق من محطة محايدة تنظر لمؤسسات الدولة بتجرد وتفترض فيها جميعا الكفاءة والحرص على الصالح العام، فهل كان أعضاء لجنة الخمسين يرون أعضاء البرلمان أكثر حرصا وإخلاصا لمصلحة الوطن من الرئيس؟ أم كانوا يؤسسون لقطب آخر ينازع مؤسسة الرئاسة في صلاحياتها، على أمل أن تنجح أحزابهم وفئاتهم في الوجود تحت قبة البرلمان وممارسة هذا التنازع بشكل مباشر، مستغلة غطاء السلطات الذي وفرته لها اللجنة؟!
أما فيما يخص المادة (131) التي تعطي البرلمان الحق فى سحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، وتجبر الحكومة على تقديم استقالتها إذا تضامنت مع عضوها المطلوب سحب الثقة منه، فهذه المادة من الممكن أن تخلق صراعا سياسيا لا حد له ولا ضابط، وكان الواجب على اللجنة إن كانت تبتغي تأسيسا حقيقيا وجادا لهياكل السلطة التنفيذية، أن تسمح بتدخل الرئيس حفاظا على استقرار الوضع السياسي، فمتى انحاز الرئيس للحكومة رجحت كفتها، ومتى انحاز للبرلمان رجحت كفته، لكن أن تُترك الأمور هكذا للأهواء الشخصية بين البرلمان والحكومة، فهو أمر لا يسهم في بناء الديمقراطية بقدر ما يخلق الفوضى.
المحليات
وضع أعضاء اللجنة مادة غارقة في المثالية، يبدو تحقيقها شاقا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، وهي المادة (180) التي تنظم عملية انتخاب المحليات، وهذا النص الذي تسبب في تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
تنص المادة على أن “تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويُشترط في المترشح ألا تقل سنّه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها”.
وللحق فإن إجراء انتخابات المحليات بنظام تخصيص نسب للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، يخلق إشكاليات عديدة، وهذه الإشكاليات هي التي عطلت إصدار قانون الإدارة المحلية طوال أكثر من 4 سنوات، كما أنها تفتح الباب لكثير من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية والتيارات السلفية الوهابية لدخول المجالس المحلية عبر القوائم، وهذه النسب لا بد من أن تكون محل نظر.
كذلك فإن فكرة القوائم التي تُخصص نسبا لفئات معينة أثبتت عدم جدواها في انتخابات مجلس النواب الماضية، وهو نظام لا تعمل به أغلب الدول المتقدمة. ولم يقدم أعضاء اللجنة وقتها تفسيرا مفهوما لقرارهم بإلغاء تطبيق النظام الفردي في الانتخابات.
إلغاء مجلس الشورى
بعدما وضعت معركة إلغاء مجلس الشورى أوزارها، قال القيادي السابق بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين، السياسي المعروف الراحل حسين عبد الرازاق، إن “اللجنة تسعى للخروج بدستور توافقي”، وتصريحه هذا يدل على أن اللجنة كانت تضم أطرافا متنازعة، أصحاب مصالح يتعاركون لتحقيق مكاسب فئوية، إذ لا يكون التوافق إلا بين متنازعين، ما يعني أن الخمسين الذين كتبوا دستور 2014 لم يكونوا في مهمة لكتابة دستور مصر، وإنما كتابة دستور يمثل توازناتهم وأوزانهم النسبية ومصالح الفئات التي يمثلونها.
وفيما يخص مجلس الشورى فإن الفئة التي تزعمها نقيب المحامين سامح عاشور والباحث السياسي عمرو الشوبكي كانت مع إلغاء المجلس، بزعم أن ذلك “يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية فيما بعد في تعيين أعضاء بالمجلس”. وكأن كل ما كان يشغل الشوبكي، عضو لجنة نظام الحكم، هو الحد من صلاحيات الرئيس، حتى لو أدى ذلك لاختراع نظام حكم غريب، وإلغاء غرفة برلمانية ثانية كان من الممكن أن يتم النص على تشكيلها وفق معايير مختلفة عن الماضي، تضمن أن تكون بيتا لتعليم الشباب السياسة، ما يسهم في تطوير الحياة السياسية، مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، بما يسهل على المجلس إدارة شؤونه.
انتخاب رئيس الجمهورية
تنص المادة (140) من دستور لجنة الأشقياء على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.
لا يمكن – حتى في أشد حالات إحسان الظن بلجنة الأشقياء – افتراض أن شيئا سوى سوء النوايا حكم صياغة هذه المادة العجيبة، فقصر مدة الرئاسة على 4 سنوات فقط أمر غير منطقي وغير واقعي، ثم كيف تكون مدة مجلس النواب 5 سنوات والرئيس 4 فقط؟ ما الذي يمكن أن ينجزه الرئيس في 4 سنوات؟ وكيف يتحمل الرئيس الجديد سنة أخيرة لبرلمان جاء في ولاية سلفه، ولا يخشى شيئا مع اقترابه من نهاية فصله التشريعي، ما يُعني احتمالات أكبر من الصراع والصدام، والمنطق التشريعي يستنكف التفاوت بين ولايتي البرلمان والرئيس، كذلك لا يمكن تجاهل أن مصر دولة استثنائية، لا يجب أن تقل مدة الرئيس فيها عن 6 سنوات، على الأقل حتى يُشرف على الانتخابات البرلمانية الجديدة قبل انتهاء ولايته، ولا يترك أمر البرلمان كاملا لخلفه.
إضافة للبُعد السابق، فإن عبارة “ولا يجوز إعاة انتخابه إلا لمرة واحدة”، جاءت عامة حاسمة مانعة لتحجيم الرئيس، فهل مثلا لو انتهت فترتا الحكم للرئيس، وجاء بعده رئيس آخر، هل من الممنوع أن يترشح مرة أخرى بعد انتهاء ولاية خلفه؟ أي حسن نوايا في ذلك؟ ومن قال إنه من حق شلة المصالح التي شكلت لجنة الخمسين أن تحجر على رأي شعب بأكمله؟ ماذا لو كان الشعب يريد الرئيس، أي رئيس؟ ألم يلجأ شعب ماليزيا إلى مهاتير محمد مرة أخرى بعد سنوات من مغادرة منصب رئيس الوزراء (المنصب التنفيذي الأول في البلاد)؟ ألم يفعلها الشعب الروسي مع فلاديمير بوتين؟ ومن قال لهم إن التداول السلمي للسلطة يكون بتقليد أعمى لبعض الدول الغربية، وهي دول مستقرة ولديها أحزاب ومؤسسات سياسية فاعلة.
الأسوأ من ذلك، والدليل الأكبر على سوء النوايا، هي العقبات والقيود التي وضعتها لجنة الأشقياء في نهاية المادة (226) الخاصة بتعديل الدستور، وتنص على أنه “في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”. أليس هذا حجرا على أجيال قادمة؟ كيف صاغ هؤلاء العواجيز مستقبلنا حسب أهوائهم؟ إن كان الشعب هو السيد وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وإن كانوا صاغوا مستقبلنا حسب أهوائهم، فلنا الحق أن نطلب الاحتكام للشعب مرة أخرى!.
الآن، وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على هذا الدستور، وانتهاء المدة الأولى للرئيس وانتخابه لولاية ثانية، وعدم تقديم التيارات السياسية التي يمثلها هؤلاء الذئاب مرشحين لخوض الانتخابات الأخيرة، وحتى من أعلن منهم عن نيته الترشح انسحب، هل يمكن أن نقول بعد ذلك إن لدينا أحزابا وتيارات سياسية قادرة على إفراز مرشحين يستطيعون تحمل مسؤولية قيادة الوطن؟.
بالتأكيد لا بد من أن يُثير هذا الأمر القلق على مستقبل الحكم في مصر، فمن يستطيع أن يخلف الرئيس الحالي بعد انتهاء مدته وقد منعوه من الترشح مرة أخرى وحرمونا من اللجوء إليه مرة أخرى؟ وكيف ننجو من الفخ إذا أعقبه آخر غير قادر على تحمل المسؤولية كما حدث في ماليزيا؟.
مواد أخرى
الصراع الذي كان مشتعلا بين أرجاء مجلس الشورى شغل أعضاء لجنة الخمسين عن الانتباه لتناقض واضح بين المادتين (107) و(210)، الأولى تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”. وتنص الثانية على أن “تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها”.
وفق هاتين الصياغتين المتضاربتين، أعطت لجنة الأشقياء للمحكمتين الاختصاص نفسه، وهو الفصل في صحة عضوية النواب.
في المادة 121 وضع أعضاء لجنة الخمسين فخا كبيرا نصه “وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له”.
هذا النص العجيب يمكن أن يضع قوانين مهمة في ثلاجة المجلس وتعطيل إصدارها شهورا طويلة لعدم اكتمال النصاب، لأن أغلب الأعضاء يتهربون من حضور الجلسات، إلى الحد الذي دفع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال للشكوى من هذا الأمر مرارا، والتلويح بإعلان أسماء المتغيبين للإعلام، والأهم تأجيل مناقشة وإقرار كثير من القوانين لأسابيع وجلسات عديدة بسبب هذا التغيب، ولا يمكن اعتبار نص لجنة الأشقياء بريئا، خاصة مع معرفة أغلبهم بطبيعة المجالس النيابية بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، ما يجعل اشتراط هذه النسب الكبيرة تعطيلا مقصودا، وليس ضمانة إيجابية كما حاولوا تصوير الأمر.
نهشتنا الذئاب.. فهل لنا علاج؟
لا تبدو الصورة الأخيرة إيجابية، مهما قلّبناها على كل الوجوه المتاحة، فالحقيقة أننا وقعنا فريسة سهلة لقطيع من الذئاب الجائعة، حضر كل منها حاملا على كتفيه وبين مخالبه أطماعا وتطلعات لا تعلو على الشبهات، بعضها شخصي وأغلبها فئوي، وخرج المجموع الشعبي الواسع غير الممثل وسط هؤلاء الأشقياء صفر اليدين تماما.
بدستور مثل الذي نعمل به الآن، وبنوايا كالتي ظهرت من ممارسات ومواقف أعضاء لجنة الأشقياء (الخمسين سابقا) لا يمكن أن يسير بلد باتزان واستقرار، ولا أن يصل لمرافئ المستقبل بهدوء واطمئنان، والمؤكد أنه سيُعاني تخبّطا وارتباكا واسعين في إدارة كثير من شؤونه، لأن من ائتمنهم على كتابة وثيقته الدستورية، والتأسيس التشريعي لهذا المستقبل المأمول، لم يكونوا أمناء أو متجردين من أهوائهم ومصالحهم الشخصية، وجميعهم خانوا الأمانة التي أُوكلت إليهم، وقامروا بحاضر الوطن ومستقبله، لقاء تأمين حاضرهم ومستقبلهم.
نريد دستورا جديدا من أجل وطن جديد ومستقبل لا يصنعه أشقياء الماضي.. نريد دستورا جديدا حتى ننقذ مصر من مخالب الذئاب.