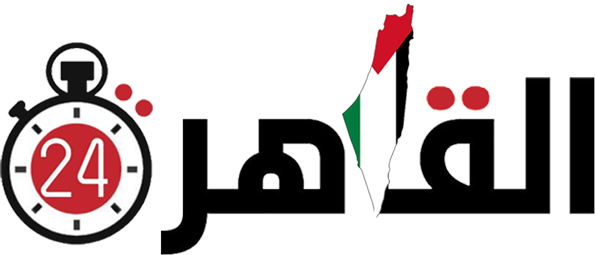عندما يحكم قانون كامبل الاقتصاد.. المؤشرات التي تضللنا بدل أن تنير الطريق
في الاقتصاد، لا تكشف الخطابات الرنانة ولا التصريحات الرسمية عن الحقيقة، بقدر ما تفعله الأرقام والإحصاءات، فالحكم على جودة السياسات المتبعة لا يُستمد من النوايا المُعلنة أو التقييم الذاتي، بل من مؤشرات ملموسة مفترض فيها أن تُقاس بأدوات موثوقة، ومن ذلك الاستدلال بمعدلات النمو والفقر والبطالة وعجز الموازنة على مدى سلامة التوجهات، خاصة وأن تلك المؤشرات لا تُجامل ولا تُزيَّف، وتُشكّل مرآة صادقة للواقع.
لكن ماذا لو تحوّلت هذه المؤشرات من أدوات لقياس الأداء إلى غايات بحد ذاتها؟.. ماذا لو أصبحت الحكومات أو المؤسسات تصوغ قراراتها لا لتحسين الواقع، بل لتحسين المؤشرات التي تُقاس بها؟.. هنا تحديدًا تتجلى الإشكالية التي يُنبه إليها ما يُعرف بـ "قانون كامبل".
قانون كامبل: حين يفقد المؤشر حياديته
في عام 1976، صاغ عالم الاجتماع الأمريكي دونالد كامبل مبدأً تحذيريًا في علم القياس الاجتماعي، مفاده أنه “كلما استُخدم مؤشر كمي كأداة لصنع القرار، زاد احتمال تعرضه لضغوط تُضعف دقته، وأصبح أكثر قابلية للتأثير على النظام الذي يُفترض أن يقيسه.
بمعنى أدق، عندما يُنتزع المؤشر من سياقه بوصفه أداة للقياس، ويُعاد توظيفه كمعيار للتقييم أو وسيلة للمساءلة، فإن النظام يبدأ في تعديل سلوكياته ليس من أجل تحسين الواقع ذاته، بل من أجل تحسين قيمة المؤشر.. وهكذا، يُفرغ المؤشر من محتواه الحقيقي، ويغدو مجرد واجهة ظاهرية لنجاحات قد تكون مصطنعة، بينما تظل المشكلات الجوهرية دون معالجة رغم أنها المستهدف الرئيسي.
ويقترن هذا المفهوم بـ “قانون غودهارت” الذي يُستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد، وينص على أنه: “عندما يُعامل مقياس ما كهدف، فإنه يتوقف عن كونه مقياسًا موثوقًا”.
في مصر: مؤشرات تحت الضغط
ويتجلى أثر "قانون كامبل" بوضوح في قراءة بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر، حيث يَطغى الحذر المؤسسي على دور الشفافية التحليلية، بما يؤدي إلى اختزال المؤشرات في صورتها الرقمية، بعيدًا عن مضمونها الحقيقي.
على سبيل المثال، لم تُحدّث بيانات الفقر الرسمية منذ عام 2020، رغم التحولات العميقة التي مر بها الاقتصاد المحلي، والتي من بينها تحرير سعر الصرف، والارتفاعات المتتالية في مستويات التضخم، والتغييرات الهيكلية في الدعم، وهو ما يحد القدرة على تقييم مدى فاعلية سياسة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ويجعل السياسات الاجتماعية تُدار دون بوصلة دقيقة.
أما معدل البطالة، فرغم أهميته كأحد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي، إلا أنه يُقاس وفق تعريف ضيق نسبيًا، يقتصر على القادرين والراغبين والباحثين فعليًا عن عمل، وهو ما يستبعد شرائح مهمة، مثل من فقدوا الأمل في إيجاد وظيفة، أو من يعملون في أنشطة هامشية تفتقر إلى الإنتاجية والاستقرار، كما أن المؤشر لا يُفصّل مستويات البطالة بين الشباب، أو التفاوتات الإقليمية، أو التخصصات التعليمية، مما يحد من قدرته على توجيه السياسات التشغيلية.
وينطبق المنطق ذاته على الفائض الأولي في الموازنة العامة، وهو مؤشر غالبًا ما يُروَّج له باعتباره علامة على الانضباط المالي، إذ نظريًا، يشير إلى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها الجارية من مواردها الذاتية، دون الحاجة إلى الاستدانة لتمويل العجز، لكن في الحقيقة قد أصبح هذا المؤشر منفصلًا عن الواقع الفعلي، إذ أن عبء خدمة الدين - من فوائد وأقساط - يستهلك الجزء الأكبر من الإيرادات العامة خاصة وأنها تفوق معظم بنود الانفاق مجتمعة.
وبالتالي، فإن تحقيق فائض أولي لا يغيّر من حقيقة الوضع، بما يجعله رقمًا معزولًا عن حقيقة المركز المالي الشامل للدولة، ويتحوّل بذلك إلى أداة رمزية في الخطاب الاقتصادي أكثر من كونه مقياسًا فعليًا على الاستقرار.
أداة تبرير وتغطية سياسية
وفي الحقيقة، فليست مصر استثناءً من تجارب دولية، فإشكالية "قانون كامبل" تتكرر في تجارب اقتصادية متنوعة حول العالم، كلما تم تجاوز المؤشر من كونه أداة قياس إلى كونه أداة تبرير أو تغطية سياسية.
ففي الهند، أثار تأجيل نشر بيانات البطالة في عام 2019 موجة واسعة من الجدل بعدما كشفت الأرقام حينها عن وصول معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، مما فُهم على أنه محاولة لتفادي الجدل السياسي مما يضعف الثقة في استقلالية الأجهزة الإحصائية.
أما في الصين، فقد أظهرت مراجعات داخلية لاحقة أن بعض الحكومات المحلية بالغت عمدًا في تقديرات تقديرات النمو المحلي، بدافع الحرص على إرضاء الحكومة المركزية وإظهار الأداء الاقتصادي في صورة أكثر نموا.
وفي الولايات المتحدة، تجلت المفارقة خلال أزمة 2008، حين استُخدمت تقييمات الجدارة الائتمانية – الصادرة عن مؤسسات تصنيف خاصة – كمعيار شبه مطلق لتحديد جودة الأصول المالية، ومع الوقت، انقطعت العلاقة بين التقييمات والواقع الفعلي لتلك الأصول، ما ساهم في تضخيم الفقاعة العقارية، وتسريع انهيارها، ليصبح المؤشر لم يفقد وظيفته فقط، بل ساعد على تفاقم الأزمة التي كان يُفترض أن يقي منها.
إنتاج المشكلات بدلا من حلها
وتُظهر الأمثلة السابقة، كيف يمكن للمؤشرات أن تتحوّل من أدوات للرصد والتحليل إلى أدوات تخدم أغراضًا سياسية أو تجارية أو إدارية، لتُعيد إنتاج المشكلات بدلًا من حلها من خلال التوصيف الدقيق، كما أنها لم تؤثر فقط على مصداقية البيانات، بل تؤدي بالتبعية إلى سوء التخطيط المستقبلي.
فعندما تُستخدم المؤشرات الاقتصادية كأساس للمفاضلة أو كأداة للتقييم العام، تتغير طبيعة التعامل معها عند البعض، فبدلًا من أن تكون وسيلة لتوجيه السياسات وتصحيح المسارات والتقييم السليم، تتحوّل تدريجيًا إلى “سقف يُخشى تجاوزه”.
وهذا ما يجعل بعض المؤسسات أو الحكومات تميل إلى التحفّظ أو التجميل بدلًا من المواجهة الواقعية، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة بين المعطى الإحصائي والحالة الفعلية، وكذا بين الأرقام والواقع، ناهيك عن إشكاليات كثيرة في التخطيط القائم على بيانات غير واقعية.
المؤشر مرآة لا تهمة
من الضروري التأكيد أن المؤشرات ليست أحكامًا ولا تهديدات، بل أدوات تشخيص عقلانية، وإذا عكست مؤشراتنا واقعًا صعبًا، فالمطلوب ليس تجاهلها أو تزيففها، بل التعامل معها كمنبهات لخللٍ يحتاج إلى إصلاح، خاصة وأن ”دفن الرأس في الرمال” لم يكن يومًا إستراتيجية فعّالة في إدارة الاقتصاد، ولا يُغني عن الحلول الواقعية.
فالنضج الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الناتج أو معدل النمو، بل بقدرة النظام على مواجهة أرقامه بشفافية، وعلى تبنّي سياسات تُبنى على ما ترصده المؤشرات، لا على ما يُراد منها أن تقوله، خاصة وأن المؤشر الجيد ليس مَن يُرضي، بل يجب أن يكون "من يُرشد".