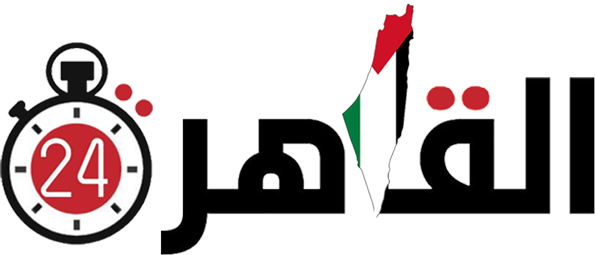أطفال الهرمونات
عاشت جدتي 82 عامًا لم تأكل فيها الفراخ البيضاء إلا نادرًا. كل العائلة تعرفُ أن جدّتي لا تشتري إلا الفراخ البلدي ولا تأكل إلا الفراخ البلدي، ويا ويلنا يا سواد ليلنا إذا زارتنا جدتي ووجدت فراخ بيضا على الأكل، لا تتركها فحسب؛ بل إنها تُشعر من يتناولها بأنه مُخطئ في حقّ جهازه الهضمي وصحته. سألتها يومًا في طفولتي "مالها يعني يا تيتا الفراخ البيضاء؟" فكان ردُّها واضحًا حازمًا قاطعًا كأنه سُبَّة "محقونة هرمونات".
أفهمتني جدتي لاحقًا أن الشيء المحقون بالهرمونات يعني أنه غير طبيعي، خوخ الهرمونات غير الخوخ البلدي، منفوخ وملهوش طعم، برقوق الهرمونات كبير على الفاضي ولا هو برقوق ولا هو مشمش، وفراخ الهرمونات تكبر سريعًا قبل أوانها لأنها فقط منفوخة بهرمونات التسمين لكنها في الحقيقة لا تُسمن ولا تغني من جوع بل تكون مضرّة ومُسببة للأمراض.
أصبحتُ أتَّخذُ "الهرمونات" مقياسًا دقيقًا للأشياء والأشخاص. فمثلًا نجاح الهرمونات الذي يأتي مفاجئًا مدفوعًا بدفقة دعائية ضخمة تجعل الشخص "ينفش" أمامك فجأة ويتضخّم ويملأ الشاشات ولوحات الطرقات دون سابق معرفة هو نجاح هرمونات، يفوقه جمالًا وطعامة وتلذذًا ذلك النجاح الذي يُطهى على مهلٍ ويَشُمُّ رائحة طبخه القاصي والداني وكل مَن يشاهد جزءًا منه يتطلعُ إلى المزيد. معارك الهرمونات؛ تلك التي تتولد من نتفة ثلج بسيطة ثم تتحوّل إلى كرة كبيرة لا تجد فيها رجلًا رشيدًا يملك أدوات الحوار والنقاش، وهكذا أطفال الهرمونات.
لا يخفى على أحد أن الفيديو المنتشر لطالبة الصفّ الثالث الإعدادي التي تشرح بضجر وغضب وأسلوب امرأة قَسَت عليها الحياة مدى استيائها من منع الغش بلجان الامتحان، لا يخفى على أحد كون هذه "الطفلة مجازًا" لا تحيا نفسيًا على الأقل بعُمر الطفولة بحالٍ من الأحوال، وأكاد أُجزم أنها لا تُعامَل كطفلة في بيتها ولا حتى كمُراهِقة، إنما هي امرأة تشارك أمها رعاية البيت والإخوة الصغار إن وجدوا، بل ربما هي تتوق لذلك اليوم الذي تصبح فيه سيّدة بيت وحيدة دون شراكة وإشراف الأم. وعلى ذلك فهي تعتبر أن التعليم بمراحله البطيئة عائقًا دون قدرتها على الوصول للحريّة الكاملة، فما بالك ورئيس اللجان يمنع الغش بما يعني صعوبة اجتياز المرحلة وتأخير الوصول!
لا ألوم هذه الطفلة تحديدًا، ولا تلك الأخرى "طالبة الأول الإعدادي" التي ردّت عليها في فيديو منفصل تُخطِّئها وتشرح لها كيف نصبح صورة مُشرّفة لمصر، وأن العِلْم وسام شرف وبلا بلا بلا وتتحدّث من علٍ كأنها واعظ يقف على المنبر. ولكنني للأمانة لا أستطيع أن أفصل هذا "الانتفاخ" النفسي الذي يمرُّ به الأطفال في مصر عن سلسلة من الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا وكان الفاعل فيها طفل واحد أو مجموعة، سواء الاعتداء الجنسي على حيوان في الشارع أو استدراج طفلة وقتلها ومحاولة إخفاء جثتها.
أنا هنا لا أدين الانتفاخ السلبي فقط، بل أيضًا الطفل "السابق سنّه" بشكل إيجابي هو مُختَرَق الطفولة. فمثلا لماذا أدعم امتلاك طفل أو مجموعة أطفال لمئات الآلاف من الجنيهات كي يبدؤوا مشروعات تجارية وهم في سن صغيرة كما في برنامج sharks؟ حتّى وإن كان الأهالي هم المسؤولون عن هؤلاء القُصّر فإن الأمر يحتاج إلى تدريب تدريجي على الإدارة المالية وإدارة المشروعات، وكل أصحاب رؤوس الأموال يدركون أهمية هذه المهارات جيدًا. فكيف انتقل طموح الطفل من العمل في أقرب سوبرماركت أو حتّى في ورشة ميكانيكي خلال إجازة الصيف إلى طموح امتلاك مشروع متكامل يُصنَِع مُنتَجًا ويصدّره؟ وما هي أسباب تجريم عمالة الأطفال من الأساس، هل هو احتمال التعرّض لأذى بدني فقط، أم أنه القفز بالطفل خارج إطار ومسؤوليات الطفولة والتي هي مرحلة تأسيسية هامة لتكوين واكتمال إدراكه ووعيه دون أن يكون مضطرًا لاتخاذ قرارات بما تستتبعه تلك القرارات من شعور "متضخم" بالمكسب أو الخسارة أكبر بكثير مما تسببه خسارة ماتش كرة في النادي أو ماتش بلاي ستيشن.
هذا النداء موجّه للمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ هناك تغيير كبير يطرأ على الطفل المصري في جميع الطبقات الاجتماعية، من حيث اهتماماته وسلوكياته بل وجرائمه التي يقوم بها في إطار التجريب. تغييرات وسلوكيات تصل إلى الاغتصاب والقتل وهذا كافٍ لإشعال حالة من الثأر والفُرقة المجتمعية والزجّ بجيل مستقبلي إلى خلف أسوار السجون، وأعتقد أنه يجب دراسة هذه الظاهرة وتحليلها قبل أن تنتفخ الهرمونات أكثر من ذلك.