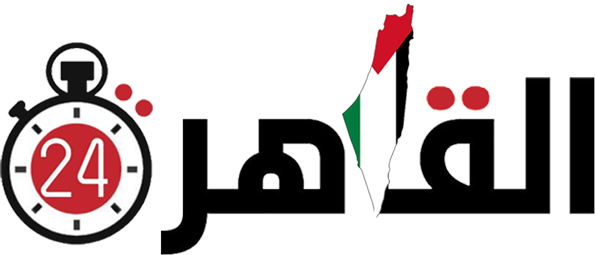أبطال من ورق.. بطولات زائفة وشائعات تبتلع الوعي
في عالمٍ باتت فيه السوشيال ميديا المصدر الأول للمعلومة، والمسرح الأكبر للرأي، تحول الكثير من الناس إلى جمهور يتفرج، وقلة قليلة إلى ممثلين في عرض يومي من التضليل والادّعاء، لكن اللافت في هذا العرض، أن الجميع فيه يُريد أن يكون البطل، حتى لو كان بطلًا من ورق.
منذ متى أصبحت البطولة مجرد منشور حاد، أو فيديو انفعالي؟ منذ متى صار الدفاع عن الوطن يتم بـ لايف على فيسبوك أو بوست مشحون بالشتائم؟ ومنذ متى صار كل من يصرخ أعلى، أو يسبّ أكثر، أو يركب موجة الترند، يُوصف بأنه شجاع أو وطني أو حتى رمز؟
لقد صنع الإعلام البديل – أو فلنقل الإعلام الموازي – نجومًا بلا مضمون، وأبطالًا لا يتحمّلون أي كلفة حقيقية سوى ضغطة زر، وجيش من المتابعين قد يصفقون اليوم، ويهاجمون غدًا، تحولت السوشيال ميديا إلى حلبة مصارعة فيها كل شيء مباح: تضليل، تهويل، تخوين، تأليه، وأحيانًا تحريض، والنتيجة؟ حالة من الفوضى الفكرية والانقسام النفسي داخل المجتمع.
ليس غريبًا إذن، أن ترى من لم يعرف شيئًا عن تضحيات الجيش، يتحدث عن الأمن القومي، ومن لم يدخل مبنى حكوميًا، يتكلم عن الدولة العميقة.
ومن لم يُدر مؤسسة صغيرة، يضع خططًا لإدارة البلد، ويوزّع الاتهامات بالمجان على المسؤولين، كل هذا دون وعي حقيقي، أو إدراك لطبيعة المرحلة، أو حتى احترام للعقول.
إن خطورة هذه الظاهرة ليست فقط في تزييف الوعي العام، بل في أنها تصنع رأيًا عامًا زائفًا، وتضع الدولة في مرمى الشائعات ليل نهار، فكل منشور غير مدقق، وكل فيديو مجهول المصدر، قد يتحول إلى قضية رأي عام، وقد يُستخدم لتأليب الناس، أو ضرب الثقة في مؤسسات الدولة، أو تشويه الرموز الوطنية.
بل الأخطر من ذلك، أن بعض الجهات المعادية للدولة باتت تعتمد على هؤلاء الأبطال من ورق، كأدوات تنفيذ، ينشرون الفوضى الرقمية تحت شعارات براقة مثل: حرية التعبير، والصحوة الوطنية، والوعي الشعبي، بينما في الحقيقة، هم مجرد بيادق في لعبة أكبر، وأدوات تهدم أكثر مما تبني.
وما لا يدركه كثيرون، أن السوشيال ميديا – إن لم تُستخدم بوعي – تصبح سلاحًا موجهًا للداخل، فكم من شائعة هزّت الرأي العام بلا سبب؟ وكم من معلومة مغلوطة بثّت الذعر بين الناس؟ وكم من مقطع مُجتزأ شحن النفوس وأثار البلبلة، ثم اتضح بعد أيام أنه مفبرك أو غير دقيق؟!
وسط هذا الزحام، يختفي الأبطال الحقيقيون، أولئك الذين يعملون في صمت، ويدافعون عن الدولة من مواقعهم بلا صوت ولا شهرة، الجنود الذين لا يعرفهم الناس، والأطباء الذين ينقذون الأرواح، والمهندسون الذين يشيدون المصانع، والمعلمون الذين يصنعون الأمل، هؤلاء لا يجدون مكانًا في الترند، لأنهم ببساطة لا يبحثون عن ترند.
أما من يعيشون داخل عالم الشاشة، ويصنعون من كل أزمة منصة للظهور، فهم لا يدركون أنهم يسهمون في تشويه الوعي العام، ويخلقون أجيالًا تظن أن الكلام بديل للفعل، وأن الوطنية صراخ لا التزام، وأن البطولة لا تحتاج إلى تضحية بل إلى فيديو جيد المونتاج.
وهنا يأتي الدور الأخطر: دور النُخب، والمثقفين، والإعلام الحقيقي، يجب أن نقاوم هذه الظاهرة بطرح عاقل، ومعلومة موثوقة، ونقد موضوعي، وتقديم النماذج الحقيقية للشباب، فلا نترك الساحة لهواة الإثارة، ولا نسمح بانهيار منظومة القيم تحت ضغط الترندات.
وفي النهاية، على كل فرد في هذا الوطن أن يُعيد النظر في ما يصدقه، وما يروّج له، وما يكتبه، لأن الكلمة الآن، لم تعد مجرد رأي، بل قد تكون رصاصة، وقد تكون خنجرًا في ظهر الوطن.
فالوطن لا يُحمى بمنشور، ولا تُبنى الدولة بلا وعي. والأبطال الحقيقيون لا يصنعهم الترند، بل تصنعهم المواقف.