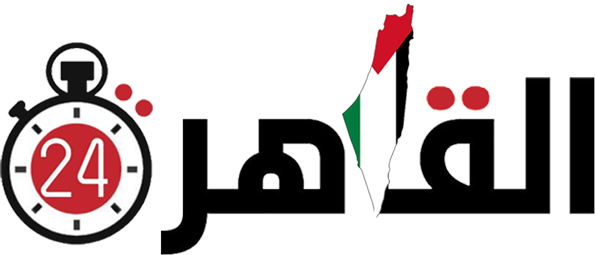18 زهرة على الأسفلت.. حين أجبرهن الفقر على العمل ودهستهن التريلا
لم يكن الفجر في كفر السنابسة كأي فجر آخر. فتيات في عمر الزهور، يحملن أحلامًا كبيرة بقلوب صغيرة، خرجن فجر الجمعة إلى حديقة العنب لا لالتقاط الصور، بل لقطف الرزق بيومية لا تتجاوز 130 جنيهًا، لا تكفي لثمن وجبة من أحد مطاعم الوجبات السريعة، لكنها كانت تكفي بالكاد لحلم بسيط... حلم بالكتب، أو طرحة العرس، أو مصروف عام دراسي.
هؤلاء لم يكنّ عاملات زراعة بالمعنى التقليدي. كنّ عاملات من نوع خاص، لم نعتد رؤيتهن في هذا المشهد:
"آية" طالبة الهندسة
"سلمى" من معهد التمريض
"يمنى" العروس التي كانت تستعد لفستان زفافها
وفتيات في المرحلة الإعدادية، ينتظرن ظهور النتيجة غدًا.. وقد ظهرت بالفعل وهنّ في قبورهن.
لم يكن المشهد فقرًا فقط، بل نتيجة مباشرة لسياسات إفقار يتم اتباعها دفعت هؤلاء الفتيات للعمل في الحقول وسط الشمس والغبار والعناقيد، بدلًا من قاعات المحاضرات أو أيام الراحة في الإجازة.
ركبن ميكروباص لا يليق بحياة آدمية، تم تحميله فوق طاقته القانونية، بعد أن حشرتهن السمسرة في كل زاوية، بلا مقاعد كافية، بلا حزام، بلا إحساس بالمسؤولية، فقط مزيد من الحمولة لمزيد من التحصيل.
وعلى الطريق الإقليمي – الموت المعتاد، دهست تريلا ضخمة الميكروباص فحولته إلى تابوت جماعي.
18 فتاة رحلن دفعة واحدة بينهن من كانت الأولى على مدرستها، ومن كانت تستعد لزفافها، ومن كانت تحلم بأن تعالج الناس يومًا.
هذا الحادث لا يمكن فصله عن:
طريق غير آمن يشهد حوادث متكررة، معروف بسوء تخطيطه وإدارته.
غياب الرقابة على تشغيل الفتيات القاصرات.
جشع السماسرة الذين يكدّسون البشر كأنهم صناديق.
صمت المسؤولين الذين لا يتحركون إلا بعد أن يعلو الصراخ على مواقع التواصل.
ولولا التدخل العاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصداره أوامر بإزالة جميع العوائق من على هذا الطريق فورًا، لربما استمر المشهد وكأن شيئًا لم يكن.
لكن يبقى السؤال المرير:
هل كان علينا أن ننتظر كل هذا العدد من الضحايا لنتحرك؟
وهل لا تُفتح الملفات إلا بعد تدخل الرئيس شخصيًا؟
ما حدث ليس مجرد حادث سير إنه جرس إنذار حاد، ودعوة لوقفة شاملة.
نحن أمام كارثة مركبة بكل المقاييس:
اقتصاد يطحن البسطاء، عدالة اجتماعية غائبة، إهمال مروري مزمن، واستسهال في تحميل الفقراء وحدهم كُلفة الأزمات.
لقد دهست التريلا 18 جسدًا بريئًا.. لكن ما هو أدهى أنها دهست ثقتنا في الحد الأدنى من الأمان.
فهل نجد لعودته سبيلًا؟