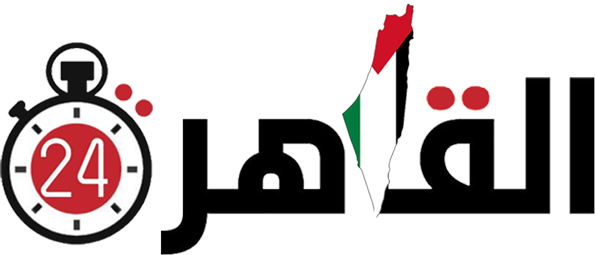حينما كانت الثقافة والمعرفة صانعة للنجوم!!
كنت من المحظوظين بأبٍ من طراز فريد حتى في أصدقائه الذين كانوا يحضرون إلى منزلنا في جلسات وسهرات وعزومات لسنوات طويلة؛ ومن ضمن هؤلاء الذين استضافهم منزلنا الفيلسوف الكبير أنيس منصور، الذي لاحظ شغفي للمعرفة رغم صغر سني وقتها.
وفي الزيارة التالية لهذه الملاحظة وجدته يقدم لي كتابا يحمل توقيعه، بعنوان: "في صالون العقاد كانت لنا أياما"؛ ولا أخفيكم سرا انني قرأت هذا الكتاب بنهمٍ شديد وأعجبت بعالمه الذي سرده منصور بأسلوب أدبي رائع؛ لم يكن صالون عباس محمود العقاد، مجرد لقاء أسبوعي في بيت أديب كبير بل كان ظاهرة ثقافية تعكس روح عصرٍ آمن، بأن الكلمة تصنع الإنسان وأن الفكر هو الطريق الحقيقي إلى النجومية وكما رواه أنيس منصور بدا الصالون أشبه بمدرسة حرة يدخلها من يملك الشغف بالمعرفة ويغادرها محمّلًا بالأسئلة قبل الأجوبة.
كان العقاد يجلس في صدر المجلس لا بوصفه شيخًا يُقدَّس بل عقلًا يُحاوَر ولا مجاملة في حضرته ولا تساهل مع السطحية فمن يتحدث عليه أن يكون قد قرأ ومن يُجادل عليه أن يفهم، وهنا تشكّل الوعي وتدرّب جيل كامل من الصحفيين والأدباء والمثقفين على احترام العقل والاختلاف، ولذلك لم يكن الصالون انعزالًا عن الشارع بل كان انعكاسًا حيًا للحياة الثقافية في مصر آنذاك.
في ذلك الزمن، كانت الثقافة نسيجًا واحدًا فالصحافة تتغذى من الأدب والإذاعة تستند إلى الفكر والفن يتحرك في فضاء واسع من الوعي ولم يكن المبدع ابن موهبته فقط بل ابن مجالسه وقراءاته ونتاجًا لنقاشاته؛ وقد أشار أنيس منصور إلى أن كثيرًا ممن لمعوا في الصحافة والإذاعة مرّوا من هذا الصالون أو تشكّلت عقولهم في أجواء مشابهة بحيث ان الكلمة مسؤولية لا زينة ورتوش.
وعندما ننظر إلى حال الفن اليوم في زمن التواصل الاجتماعي والتيك توك سندرك حجم ما نفتقده، فالفنان النجم المعاصر غالبًا ما يصعد سريعًا محمولًا على أكتاف الشهرة لا المعرفة والثقافة أو كُتاب ومفكرين يجاورونه أو أسئلة تقلقه بل اكتفي باللايكات والتعليقات من زوار التواصل معدومي الهوية والمصدر او من اللجان الاليكترونية التابعة له والتي غالبا ما تتغني به علي طريقة (يا حلاوتك يا جمالك)!!
وعلى العكس من ذلك كان نجوم مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ علي سبيل المثال وليس الحصر جزءًا من مشهد ثقافي حقيقي يجالسون من خلاله كبار الأدباء والكُتاب ويستمعون للنقد والرأي ويدركون أن الفن ليس صوتًا جميلًا فقط او أداءا تمثيليا لشخصية سوقية او شعبية بل موقفًا ووعيًا ورسالة.
لم تكن عظمة إفرازات الفن في ذلك العصر صدفة بل نتيجة طبيعية لوجود قامات فكرية كبرى، فحين يكون العقاد، وطه حسين، وتوفيق الحكيمزوأمثالهم حاضرين في المجال العام، فإن الذوق يرتقي والاختيار يصبح أدق والجمهور نفسه يتعلم كيف يميّز بين ما يُسمَع ويشاهد ولذلك الأغنية كانت تعيش لعقود، والمقال الصحفي كان يُقرأ كعمل أدبي والبرنامج الإذاعي كان نافذة على العالم والفيلم كان فيلمًا سينمائيًا والمسرح وغيرها.
واليوم في غياب هذه القامات ومع تراجع دور الصالونات الثقافية والاعتماد على انتشار السوشيال ميديا، أصبح الفن أسرع وأكثر هشاشة لا لأن الموهبة قد اختفت بل لأن المعلم قد غاب والحوار قد تراجع والعمق لم يعد شرطًا للنجاح بل حل محله السوقية والبطولات الزائفة والأبطال من محدثي النعمة!!
إن استعادة روح صالون العقاد ليست عودة إلى الماضي بقدر ما هي دعوة لإعادة الاعتبار للعقل بوصفه شريكًا أساسيًا في الإبداع فحين كان العقل نجمًا أضاء الفن طويلًا وحين غاب صارت الأضواء أسرع انطفاءً وتصدر المشهد المصري عقولا خاوية ونفوسًا مريضة لا تدرك حجم المسئولية ولا الهوية المصرية بل تعرف أنواع السيارات والساعات والملابس البراند التي بالمناسبة لا تليق عليهم!!.