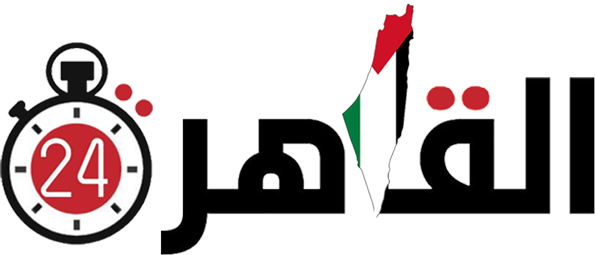سجال «العربية» و«المالية».. ولعنة «كامبل»
خلال الأيام الأخيرة، تصاعد سجال غير معتاد بين وزارة المالية وقناة العربية، على خلفية تقرير متلفز تناول الوضع الاقتصادي وأرقام الدين العام، إذ استدعى الأمر ردًا من وزارة المالية وصفت فيه التقرير بأنه غير مهني وقد يضلل الرأي العام، ويعتمد على عرض غير كامل للمعلومات.
غير أن جوهر هذا السجال- في رأيي-، لا يتمحور حول رقم بعينه، بقدر ما هو خلاف حول طريقة قراءة الواقع المالي، وهو في حد ذاته أمر صحي؛ فالنقاش العام حول الدين والموازنة، مهما بدا صاخبًا، هو علامة تفاعل وحيوية لا دلالة أزمة، طالما ظل النقاش محكوما بالأدوات التحليلية ولم تتحول المؤشرات من أدوات قياس إلى غايات مستهدفة.
تقرير «العربية» تحدث على القفزة الكبيرة في إصدارات أدوات الدين خلال النصف الأول من العام المالي، ودلالة ذلك على تفاقم الضغط على المالية العامة واستمرار الحلقة المغلقة بين العجز والاقتراض والفوائد، وزارة المالية من جانبها ردّت بأن هذا الطرح غير مهني لأنه يخلط بين الإصدارات وبين رصيد الدين، مؤكدة أن المعيار الصحيح هو صافي الاقتراض بعد خصم الإهلاكات والسداد.
فنيًا، ما قالته وزارة المالية صحيح، فالدين لا يزيد لمجرد أن الدولة أصدرت أدوات دين جديدة، بل يزيد إذا كان صافي ما اقترضته يفوق ما سددته، لكن الاكتفاء بهذا التصحيح المحاسبي يُغفل سؤالًا اقتصاديًا أعمق: لماذا أصبحت دورة الاقتراض نفسها بهذه الكثافة؟
وحتى لو كان جزء كبير من الإصدارات هو في حقيقته تجديدًا لاستحقاقات قديمة، فإن تضخم الرقم يعكس ضغطًا نقديًا مستمرًا، ويشير إلى اعتماد متزايد على أدوات قصيرة الأجل لإدارة فجوة سيولة جارية، لا إلى تحسن هيكلي في إدارة الدين.
والأرقام هنا كاشفة، فاستحقاقات أذون الخزانة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بلغت نحو 3.3 تريليون جنيه، بينما وصلت الإصدارات الجديدة خلال نفس الفترة إلى قرابة 6.17 تريليون جنيه، وبذلك يكون هناك توسع صافي في الإصدارات بنحو 2.875 تريليون جنيه يتجاوز مجرد تجديد الاستحقاقات.
وهذا الفارق الكبير يعكس اعتمادًا متزايدًا على أدوات قصيرة الأجل لتمويل فجوة نقدية جارية داخل الموازنة، ويدل على مشاركة مكوّن من التدفقات السريعة، دون أثر هيكلي ملموس على إطالة آجال الدين أو خفض مخاطر إعادة التمويل.
من هنا، يصبح الجدل بين الطرفين أقل حدّة مما يبدو، وتقرير العربية ربما صور الإصدارات مرادفًا مباشرًا لزيادة الدين، ووزارة المالية بدورها بالغت حين اعتبرت الحديث عن كثافة الإصدارات تضليلًا كاملًا، بدل أن تقدّم تفسيرًا هيكليًا لأسباب هذا التسارع.
في سياق الرد، لجأت وزارة المالية إلى إبراز تحسن مؤشرات المخاطر، وعلى رأسها انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد CDS إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، فضلًا عن تراجع عوائد السندات الدولية، وهذه مؤشرات إيجابية بلا شك، تعكس تحسنًا في تقييم الأسواق الخارجية للاقتصاد المصري، لكن تحويلها إلى حسم للجدل الداخلي حول كلفة الدين والموازنة يظل محل جدل.
فالـCDS، في النهاية، سوقه ضيق نسبيًا، ويتأثر بتدفقات محدودة قد لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، والأهم من ذلك أن السؤال الذي يهم المواطن وصانع القرار ليس هل انخفض المؤشر، بل هل استفادت الدولة فعليًا من هذا الانخفاض في تكلفة الاقتراض، كما أنه إذا كانت آخر إصدارات اليوروبوند قد تمت بعائد يقارب 7.8%، فإن المسافة بين تحسن المؤشر النظري وبين الكلفة الفعلية للتمويل لا تزال قائمة.
وتزداد هذه المفارقة وضوحًا إذا وضعناها في سياق السياسة النقدية، فقد شهد عام 2025 خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بنحو 7.25 نقطة مئوية، ومع ذلك لم تنخفض كلفة الدين الحكومي سوى بنحو 1 إلى 2 نقطة مئوية في أفضل التقديرات، وهذه الفجوة تعكس إما بطئًا شديدًا في انتقال أثر السياسة النقدية إلى الموازنة، أو استمرار علاوة المخاطر وضغوط إعادة التمويل، أو كليهما معًا، بمعنى أنه حتى حين تُخفض الدولة الفائدة، قد لا تشعر الموازنة ولا المواطن بأثر سريع، لأن هيكل الدين نفسه يفرض شروطه.
أما عن الإيرادات، فقد شددت وزارة المالية على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية تجاوز 32%، وعلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، وهذه أرقام لا يمكن إنكارها، لكن هنا تحديدًا تظهر ما يمكن تسميته بلعنة كامبل في السياسات العامة.
ذاك المصطلح الذي يعود إلى عالم الاجتماع الأمريكي دونالد كامبل، والذي ينص قانونه على أن أي مؤشر كمي يُستخدم لاتخاذ القرار، كلما زاد الاعتماد عليه، زادت قابليته للتشويه، سواء عبر التلاعب في طرق القياس أو إعادة توجيه السياسات لتحسين الرقم لا الواقع الذي يفترض أن يعكسه.
في السياق الاقتصادي والمالي، تظهر لعنة كامبل بوضوح عند التعامل مع مؤشرات مثل الدين إلى الناتج المحلي، أو العجز، أو الفائض الأولي، إذ تتحول هذه المقاييس من أدوات لفهم الاتجاهات العامة إلى غايات بحد ذاتها، فتُصاغ السياسات أحيانًا لخدمة الرقم وليس لمعالجة الاختلالات الهيكلية الكامنة خلفه.
وخطورة لعنة كامبل لا تكمن في المؤشر ذاته، بل في إساءة استخدامه، حين يُنتزع من سياقه، أو يُقدَّم باعتباره حقيقة نهائية لا قراءة نسبية، وهو ما يفرغ النقاش العام من مضمونه، ويحوّل الجدل الاقتصادي من فهم الواقع إلى صراع أرقام، بما يفقد المقياس قيمته.
فليس كل نمو في الإيرادات الضريبية انعكاسًا لتوسع اقتصادي حقيقي، خاصة وأن جزءا معتبرا من هذا النمو قد يكون ناتجًا عن ارتفاع كلفة التمويل نفسها، والدليل الرقمي بالغ الدلالة أن الضرائب المحصلة على أدوات الدين وحدها تبلغ نحو 220 مليار جنيه، وإذا كان الفائض الأولي المعلن 383 مليار جنيه، فإن الفائض المصفّى بعد تحييد هذا المكوّن يقترب من 163 مليار جنيه فقط.
المغزى هنا ليس التقليل من الإنجاز، بل إعادة توصيفه بدقة، فحين يتحول الأثر المالي للدين إلى دليل على تحسن الأداء، نفقد القدرة على التمييز بين إيراد ناتج عن نشاط اقتصادي حقيقي، وإيراد ناتج عن تضخم كلفة الدين.
الأمر نفسه ينطبق على الحديث عن نمو الاستثمارات الخاصة وتحسن أداء الصادرات، فهذه أيضا إشارات إيجابية بلا شك، لكنها تظل عامة ما لم تُترجم إلى أرقام تشغيلية واضحة: كم زادت الصادرات؟ في أي قطاعات؟ وبأي وتيرة مقارنة بنمو الواردات، خاصة السلع الوسيطة والخامات، لأن تصديرًا أعلى مصحوبًا باستيراد أعلى لا يحل مشكلة العجز التجاري، ولا يخفف الضغط على العملة والتمويل.
في جوهر هذا السجال، نحن أمام تطبيق حي لقانون كامبل، فحين نُطارد مؤشرًا بعينه، كنسبة الدين للناتج أو الفائض الأولي أو تحسن مؤشر المخاطر، يتحول المؤشر من أداة قياس إلى قناع، ونبدأ في تكييف الخطاب والسياسات لخدمته، بدل أن يخدم هو فهمنا للواقع، والنتيجة تكون نقاشًا مشوشًا، يشعر فيه المواطن أن الدولة تتحدث بلغة أرقام، بينما حياته اليومية محكومة بالفوائد والأسعار والخدمات.
وهنا نصل إلى الفيصل الحقيقي، وهو المواطن، فما يهم الناس في النهاية ليس اتجاه المؤشر، بل متى سيشعرون بالأثر، وكيف سينعكس ذلك على قدرتهم على العيش والعمل والادخار، وهل ستنخفض كلفة التمويل على المشروعات؟ وكذا موقف تحسن الخدمات فهل سيبقى للدولة هامش حقيقي للإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمار؟.. وهذه الأسئلة لا تُجاب بمؤشر واحد، بل بمسار متكامل يشعر به الناس تدريجيًا.
ولهذا، فإن الخطاب الاقتصادي نفسه يحتاج إلى تعديل، فلا يكفي أن نقول إن المؤشرات تحسنت، بل يجب أن نوضح كيف ومتى سينتقل هذا التحسن إلى حياة المواطنين، وفي هذا السياق، من المهم أن نُحيّي تقرير «العربية» لأنه فتح نقاشًا ضروريًا، كما نُحيّي وزارة المالية على ردّها، حتى وإن جاء بنبرة غاضبة، فالرد في حد ذاته دليل على إحساسها بالمسئولية والمساءلة، وهو أمر إيجابي.
الخلاصة أن المشكلة ليست في الأرقام ولا في النقد، بل في كيفية استخدامهما، وإذا أردنا كسر الحلقة، فلا نحتاج إلى مؤشرات جديدة بقدر ما نحتاج إلى وضوح أكبر وصدق أكبر في الربط بين الأرقام والواقع، وحينها فقط تتحول المؤشرات من أهداف نلهث خلفها، إلى أدوات تساعدنا على فهم الواقع وإصلاحه، لا تجميله، وقبل ذلك أثر مباشر على الناس.