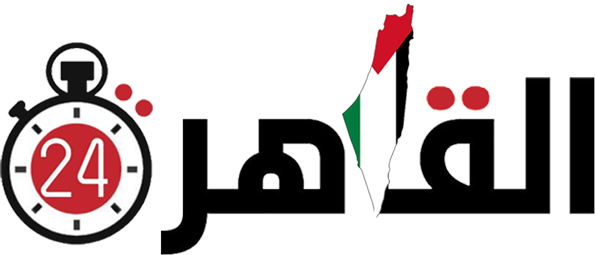إذا أشرقت شمس أمتنا زال الظلام من العالم

الإنسان، رغم كل ادعاء التقدم والتحضر، لا يزال يحمل في داخله تلك النزعة البدائية التي تميل إلى الخرافة أكثر من الحقيقة الأقرب للهمجية منها إلى الرقي والتحضر، وأيضا للشهوة أكثر من القيم، وكذلك لتغليب القوة على العدل.
تبدّلت الأشكال، وتغيرت المدن، وتطورت الوسائل، لكن الجوهر الإنساني لم يتبدل كثيرًا.
ولم يعرف التاريخ زمنا تخلصت فيه البشرية من تلك النزعات، ومن أغلب شرورها، كما حدث حين بُعث نبينا محمد ﷺ بالرسالة الخاتمة.
لم تكن دعوة دينية تُؤدى طقوسها فحسب، بل كانت ميلادًا لمشروع حضاري كامل، أعاد صياغة الإنسان أخلاقيا قبل أن يعيد بناء العالم من حوله، فخرجت أمة تعرف معنى الرحمة كما تعرف معنى القوة، وتقود بالعدل كما تقود بالعلم.
وظل ذلك لقرونٍ كان فيها مجد الأمة في أوجه، وكانت قبلة للمعرفة، وملاذا آمنا للإنسانية، ومصدر إلهام حتى لمن لم يعتنق الإسلام.
لكن حين انشغل الناس، وتفرقوا، وعادوا إلى لهوهم، يلهثون خلف سراب الدنيا، عادوا إلى ضلالهم القديم، وانطفأ النور بأيديهم قبل أن يطفئه أحد.
إنها حقيقة لا يريد كثيرون مواجهتها.
فعندما غابت شمس أمتنا، لم يغب نورها عنا وحدنا، بل خيّم الظلام على العالم كله.
ومن جاء بعدنا لقيادة العالم لم يكن أرحم ولا أعدل، بل كانوا وما زالوا طغاة ولصوصًا وقتلة، لا يعرفون شرفا ولا عهدا، تحكمهم المصالح لا القيم، وتديرهم القوة لا الإنسانية.
وربما من الحظ العاثر أننا جئنا في هذه الحقبة الزمنية البائسة، التي يندر فيها الأمل، ويكاد المعنى يضيع وسط هذا الضجيج.
نعم، نحن نعيش عصرا مذهلا في العلوم والتكنولوجيا.
الإنسان يطير في السماء، ويغوص في أعماق البحار، ويصنع آلات تفكر وتحلل وتقرر.
لكن، في المقابل، ما زالت الهمجية هي الحاكمة، وما زالت البدائية هي المسيطرة.
تقدمت الآلة… وتراجع الإنسان.
جاء الإسلام يوما ليعلم البشر ستر العورة وصون الجسد وربط الكرامة بالأخلاق، فجعل الحياء قيمة، والعفة شرفًا.
أما اليوم فنرى من يروج للعري باعتباره تحضرا، وللانفلات باعتباره رقيًا، وكأننا لا نسير إلى الأمام كما يزعمون، بل نعود القهقرى إلى الخلف، لكن بأسماء براقة وشعارات خادعة.
حضارة تتحدث كثيرًا عن الحرية، لكنها تعجز عن حماية الإنسان من الاستغلال.
تتباهى بحقوق الإنسان، بينما تغض الطرف عن الحروب والمجازر والمجاعات.
وكلما كُشف الستار عن ممارسات بشعة وقعت في قلب العالم الذي يُقال عنه متحضر، ازددنا يقينا أن البريق خارجي فقط، وأن الداخل لا يزال مظلمًا كما كان.
ولهذا يبدو العالم اليوم قويا في مظهره، هشا من داخله وغنيا في أدواته، فقيرا في قيمه.
وكما كان العالم قديما يحتاج إلى ميلاد أمة جديدة تخرجه من ظلماته، فإنه اليوم في أمسّ الحاجة إلى عودة تلك الأمة من جديد؛ أمة تعيد إليه عقله المفقود، وتذكره بمعنى العدل والرحمة والإنسانية، قبل أن يبتلعه طغيان المادة.
فإذا أشرقت شمس أمتنا.. زال الظلام من العالم كله.
فهل نجد من يبدأ؟
هل ينهض من يوقظ هذه الأمة من نومها الذي طال لتعيد إلى العالم إنسانيته المفقودة؟
أم يظل ذلك حلما جميلا… بعيد المنال؟