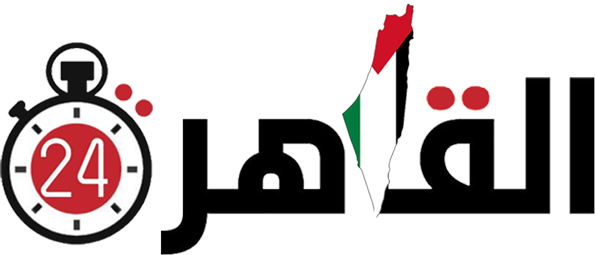"مصر الكبرى" لا إسرائيل ولا خلافه
مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما أطلق عليه "إسرائيل الكبرى"، والتي تمتد حتى تضم تحت هيمنتها وحدودها المتخيلة عددًا من الدول العربية ومن ضمنها مصر، ذهب خيالي بعيدًا.. إلى آلاف السنين، لأتأمل حكمة الأجداد وأعود إلى اللحظة الآنية مرة أخرى، وكأن بيدي الحل الذي تركوه لنا.
فرئيس الوزراء الإسرائيلي، يسوق هلاوس شخصية على نبوءات توراتية على توليفات تلمودية على مخادعات يخاطب بها الداخل الإسرائيلي كنوع من الهروب للأمام.
وسألت نفسي ماذا لو لم تكن الدولة المصرية عاقلة وراشدة رشد تاريخي يعود لآلاف السنين؟ كيف كان ردها ليكون؟
وبمزيج من خبرتي الأكاديمية في تاريخ مصر القديم، وتجربتي الدبلوماسية في صفوف خارجيتها، قلت: كان من الممكن أن نتحدث عن رؤى وإلحاحات من الماضي وضرورات تركها لنا الأسلاف تفيد بأن على المصريين تحقيق حلم "مصر الكبرى"!
ومصر الكبرى هنا لم تكن وهما ولا دعاية سياسية بل كانت واقعا متكاملا أقره المصريون ببراعة في قرون خلت من هذا الزمان.
فبعدما تخلصت مصر من الاحتلال الهكسوسي الذي خلف فيها أثرًا سلبيًا عميقًا، وكان بمثابة نقطة انكسار نفسي عنيفة، تعاهد المصريون أن يعبروا هذه التجربة البشعة، وأقسموا ألا تتكرر.
فتوسعت حدود الدولة في اتجاهاتها الأربعة، لترتسم على إثرها أمبراطورية مترامية الأطراف، يجوز تمسيتها بالإمبراطورية الدفاعية، ويجوز وصف حروبها وحملاتها العسكرية حينذاك لو أننا استعرنا مصطلحات اليوم بأنها "حروب وقائية".
فقد طارد المصريون فلول الهكسوس حتى "جاهي" في لبنان، وأعادوا التفكير في حدودهم الشرقية والخطر الذي يتربص بهم من ناحيتها على الدوام. فانكب المصريون على خرائط الإقليم بأكمله، وارتأوا أن حدود دولتهم ونطاق سيطرتها ينبغي أن يمتد حتى سوريا في الشمال الشرقي وبرقة غربا، بل وصلت قواتها إلى حدود نهر الفرات بالعراق وسيطرت على جزر وسواحل البحر المتوسط شمالا، ناهيك عن العمق الجنوبي الذي قطع أشواطا بعيدة.
لقد أدركت مصر أن سلامها الشخصي من سلام الشرق الأوسط بأكمله، فتوسعت حتى تضبط الموازين وتقر السلام رغم أنف الجميع، وسيطرت حتى تكتب لنفسها الأمان.
وقد أحبطت مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد موجات شعوب البحر الذين اجتاحوا بلاد الحيثيين وسورية وشمال إفريقيا، ممثلين تهديدا كبيرا لكل هذه النطاقات الجغرافية المتصلة. وكانت هذه الموجات العدائية واسعة النطاق متعددة الجبهات دافعًا للتفكير الاستراتيجي المصري لنشر قوات مصر بعيدا عن ضفاف وادي النيل لأجل تأمين هذا الوادي وتحقيق سلامه.
بل ومن المدهش أن نصوص الأسرة الثامنة عشرة تحمل مدلولا لا يمكن تفويته. فقد كان جيش البلاد في عصور مضت يحمل لقب "جيش جلالته" أو "فرقة آمون" أو مثل هذه التسميات التي توحي بألوهية السلطة في مصر القديمة وأن الجيش يحارب في سبيل الإله/ الفرعون، أو بتوجيهه.
لكن مع الأسرة الثامنة عشر وحين استطالت وتمددت مصر من دولة عظيمة إلى قوة إقليمية مهمينة ومنيعة وقادرة على صد العدوان أيا كان اتجاهه، حملت البرديات والنقوش وصف الجيش المصري حينها بأنها "جيشنا". فهو لم يعد جيش جلالته ولا جيش آمون.
وهو تعبير يذكرني عنوة ببيان القوات المسلحة المصرية إثر توجيه ضربة لبعض المتطرفين الدواعش في دولة ليبيا قبل نحو عشر سنوات إثر جريمة قتل عدد من المصريين هناك بعد اختطافهم. فقد صدر البيان بجملته الافتتاحية الشهيرة "قامت قواتكم المسلحة".
ففي فترات الوطنية والتكاتف والتلاحم والعزة يشعر المصريون دوما أن الجيش جيشهم جميعا، وليس مجرد تشكيل عسكري يخص الإله أو سواه.
مرت أمام عيني هذه الوقائع وهي غيض من فيض، وهي هوامش على متون من تاريخ مصر القديمة، لكني أتقيد بمساحة المقال وطابعه الذي يفرض الاقتضاب.
وبينما تتوالى هذه الصفحات أمام عيني، قلت ماذا لو أن الدولة المصرية ردت على نتنياهو بأننا استيقظنا ذات يوم على رؤى ومنامات من أحمس أو من حكام الأسرة الثامنة عشر، توجب علينا وتحملنا مسؤولية استعادة مساحة مصر القديمة وبسط نفوذها وسلطانها على كل هذا؟
ماذا لو كان تاريخ مصر القديم وهو قطعي الثبوت هو المرجع الذي سنتلاسن به أمام الهلاوس التوراتية ظنية الثبوت من الناحية التاريخية، والمستخدمة يقينا ضمن ألاعيب الصهيونية الوحشية الكذوبة؟
أقول لنفسي وأكرر إن مصر دوما كانت دولة راشدة، تضبط لغتها ولا تنجرّ لمهاترات وتفاهات، رغم وفرة الوقائع والحقب التي يمكن أن تحاجج بها بحق أو بلجاجة لإضفاء شرعية على مسالكها السياسية والعسكرية اليوم.
وأقول أن هذا الماضي حاضر، ليس بقوة الاستدعاء والمباهاة والمجادلة فحسب، بل بهذه التجربة الحضارية المذهلة التي خلفت دروسها ووعيها بالتاريخ في جينات المصريين. فهم يتصرفون اليوم وفي خبرتهم الجماعية الموروثة من أيام أحمس، يدركون أبجديات اللعبة ويحفظونها عن ظهر قلب.